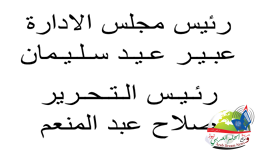تأليف: محمد تمام
في تلك الليلة الشتوية التي لم يعرف لها الحي العتيق مثيلاً، لم تكن السماء تمطر فحسب؛ بل كانت تفتح أبواب السماء على مصراعيها، منزلةً غيثاً مباركاً انهمر فوق أزقة المدينة الضيقة، التي بدت تحت رذاذ المياه المتلاحق كأنها عروقٌ حية ترتوي بعد عطشٍ طال أمده. كانت حبات المطر تتراقص فوق أرصفة “البازلت” السوداء كأنها قطع ماسٍ مبعثرة، ثم تبتلعها العتمة من جديد لتترك المجال لصوت المطر وهو يعزف لحن السكينة الرتيب فوق الأسطح الخشبية المائلة.
كانت الرياح تحمل معها رائحة الجبال البعيدة، وتداعب أبواب المحلات المغلقة التي أعلن أصحابها الاستسلام لسلطان المطر، إلا مكاناً واحداً كان ضوؤه المصفر ينبعث من خلف البخار كأنه منارة لسفينة تائهة في بحر من الظلمات. في قلب تلك الأزقة، حيث تعانق رائحة الأرض الطيبة عبق التاريخ الذي لا يموت، كان مقهى “العم إدريس” يقف شامخاً كحارسٍ أصيل رفض أن تنال منه السنون أو تنحني قامته أمام العواصف. لم يكن المقهى بالنسبة لأهل الحي مجرد جدران وأبواب، بل كان بيتاً دافئاً لكل عابر سبيل، ومستودعاً أميناً لأسرار القلوب التي أتعبها الرحيل. كان زجاجه الأمامي الضخم يكتسي بطبقةٍ كثيفة من البخار، رسمت عليها قطرات الماء المتسللة جداولاً صغيرة تمنح الجالسين بالداخل شعوراً بالعزلة الجميلة عن صخب العالم الخارجي.
خلف المنضدة الخشبية العريضة المصنوعة من خشب الساج الفاخر، والتي صُقلت حوافها وصارت ملساء تماماً من فرط اتكاء الزبائن المحبين عبر العقود، كان “يونس” يقف بوقارٍ لافت. رجلٌ في مقتبل الأربعين، ذو ملامح سمراء أصيلة نحتتها شمس المدينة وظلال المقهى، يمتلك عينين واسعتين تسكنهما طمأنينة رجلٍ تصالح مع قدره وانتظاره. لم يكن يونس يدير مجرد مشرب، بل كان يحرس حكاياتٍ بدأت قبل أن يخطو خطواته الأولى. كان يتحرك بين الطاولات بخفة فطرية، ينظم الفناجين الصينية المزينة بنقوشٍ يدوية زرقاء، ويمسح بقطعة قماش قطنية بيضاء كل قطرة ماء قد تشوه لمعان الرخام البارد.
كانت الأجواء تفوح برائحة الهيل النفاذة الممزوجة بعبير البن العربي الأصيل الذي يُحمص على نارٍ هادئة في ركن الموقد النحاسي. كان هناك مزيج ساحر من الروائح؛ لمحة ذكية من رائحة القرفة والزنجبيل، وعبير أوراق النعناع الطازجة، وخشب الصندل الذي كان يونس يحرص على إشعاله في الأمسيات الماطرة ليطرد برودة الجو. الجدران كانت مزينة بصور قديمة لشخصيات مرت من هنا، وبقايا ملصقات لمسرحيات وعروض سينمائية من حقبة الستينات، تآكلت أطرافها لكنها ظلت تحتفظ ببريق الذكرى.
وفي ركنٍ قصي، كان المذياع الخشبي الكبير، ذو الأزرار العاجية، يبث بصوتٍ نقيّ مواويل “ناظم الغزالي”، يليه صوت “ليلى مراد” الحنون وهي تشدو بألحانٍ تعيد الروح لزمنٍ كان فيه كل شيء أكثر بساطة وعمقاً. وسط هذا الهدوء المنتظم، كانت تبرز تلك الساعة الجدارية الضخمة التي تعتبر قلب المقهى النابض. ساعة مصنوعة من خشب الأبنوس الأسود، مرصعةً بصدفٍ بحريٍ نادر يعكس الضوء الخافت بتموجات لؤلؤية. كان بداخلها رقاصٌ نحاسي يلمع كذهبٍ عتيق، لكنه كان معلقاً بلا حراك، وعقاربها السوداء الحادة كانت قد توقفت بدقةٍ متناهية عند العاشرة وعشر دقائق.
بينما كان المطر يشتد في الخارج، محولاً الشوارع إلى مرايا تعكس أضواء المصابيح الشحيحة، سُمع صوت صريرٍ حاد في باب المقهى. لم يكن طرقاً، بل كان اقتحاماً هادئاً. دخلت امرأةٌ يلفها معطفٌ جلديٌ أسود يلمع تحت ضوء المصابيح المصفرة كأنه جلد أفعى أسطورية. كانت تقطر ماءً، لكن مشيتها كانت تتسم بثباتٍ مريب، لا ينم عن امرأةٍ هربت للتو من عاصفةٍ تقتلع الأشجار. كانت عيناها تحملان بريقاً ذكياً يشبه بريق البرق الذي يضيء سماء المدينة، وفي نظرتها شيءٌ من “تعارف” قديم يسبق الزمان والمكان.
وضع يونس القماش الذي يمسح به الفناجين ببطء، واقترب منها بخطواتٍ مثقلة بالحذر والترقب:
— “أهلاً بكِ يا سيدتي في رحاب مقهى العم إدريس. الجو في الخارج لا يرحم، والمقهى على وشك الإغلاق، ولكن لا يليق بقدومكِ إلا كوبٌ من ‘السحلب’ المزين بالفستق الحلبي، فقد جئتِ في وقتٍ يحتاج فيه المرء لدفء الحكايات.”
توقفت المرأة عن مراقبة الساعة الجدارية، ولم تجلس كأي زبون عادي. بدأت تخلع قفازاتها السوداء ببطء شديد، إصبعاً تلو الآخر، وعيناها مثبتتان على وجه يونس. لم تجبه عن عرض الشراب، وبدلاً من ذلك، أخرجت من حقيبتها الجلدية غرضاً صغيراً ووضعته فوق الرخام بوقعٍ رنّ في أرجاء المكان الصامت.
كانت “ساعة جيب” نحاسية، متطابقة تماماً مع الساعة الجدارية الكبيرة، وعقاربها متوقفة هي الأخرى بجمودٍ غريب عند العاشرة وعشر دقائق.
قالت السيدة بصوتٍ رصين له رنة الذهب، لكنه حاد كالشفرة:
— “الانتظار في الداخل يا يونس، أصعب بكثير من المطر في الخارج. كرمك يتوارثه القلب قبل اليد، وهو يذكرني بأيامٍ خلت، حين كان والدك إدريس يستقبلني بنفس الحفاوة. لقد كبرت يا بني، وأصبحت نسخةً من والدك، لكنك لا تزال عالقاً في دقيقته الأخيرة.”
تراجع يونس خطوة، واصطدم ظهره بالرف الخشبي، وشعر ببرودة غير طبيعية تتسلل إلى عروقه:
— “ماذا تقصدين؟ أي دقيقة؟ ومن أنتِ لتتحدثي عن والدي وكأنكِ ظلٌ له؟”
اقتربت منه السيدة حتى صار يشم رائحة غريبة تنبعث من معطفها؛ لم تكن رائحة مطر، بل كانت رائحة “الورق القديم” والمكتبات المهجورة. مدت يدها الباردة ولمست يده المرتجفة، وقالت بهمسٍ يبعث القشعريرة:
— “انظر إلى الساعة خلفك يا يونس. هل تسمع صمتها؟ هي لا تتعطل لأن تروسها صَدِئت، هي تتوقف لأنها تنتظرك. والدك لم يرحل لأنه أراد الهرب، بل رحل لأنه اضطر لتبديل مكانه بمكانك، ليبقى الزمن جارياً في عروقك أنت، بينما يتجمد هو في عروق الغياب.”
تجمدت أصابع يونس، وشعر أن المكان بدأ يضيق، وأن صوت المطر في الخارج قد تحول إلى صرخات استغاثة قديمة.
لمع البرق في تلك اللحظة بقوة هزت أركان المقهى، وانعكس الضوء على وجه السيدة الغامضة، فبدا ليونس لثانية واحدة وكأن ملامحها تستحضر طيفاً من ذاكرة طفولته البعيدة. أشاحت السيدة بوجهها عن الساعة، وأخرجت من جيب معطفها منديلاً قماشياً قديماً، مطرزاً بخيوط ذهبية دقيقة تحمل الحروف الأولى من اسم والده وأمه (إ. م)، ووضعت بجانبه غرضاً ثالثاً: مفتاحاً نحاسياً طويلاً، له رأسٌ مزخرف على شكل “زهرة اللوتس”، وبدت عليه آثار السنين لكنه كان نظيفاً ولامعاً كأنه استُعمل للتو.
وقالت بنبرةٍ يمتزج فيها الحنين بالوعيد:
— “أنا لستُ غريبة يا يونس، أنا الصدى الذي تركه والدك خلفه في تلك الليلة لكي لا يضيع الطريق. والدك لم يغادر الحي هرباً من مسؤولية، ولم يرحل لأنه سئم المكان، بل رحل ليحمي هذا المقهى، ويحميك أنت بالدرجة الأولى. لقد كان هناك دينٌ ثقيل للزمن، وقرر هو أن يدفعه من سنوات عمره لكي تعيش أنت في ‘وقتٍ مستقطع’ من الأمان. لقد آثر أن يبتعد بنفسه، ويأخذ على عاتقه رحلة الشتات ليفتديك بوجوده، وترك معي هذه الأمانة العظيمة.”
توسعت عينا يونس، وامتلأت بالدموع التي حاول حبسها طويلاً:
— “إذن كان يحميني؟ طوال تلك السنين كنت أظن أنه غادر لسببٍ أجهله، لكنني لم أشك يوماً في حبه. أخبريني يا خالة مريم، أين هو الآن؟ هل يمكنني رؤيته؟”
أجابت مريم بصدقٍ يغلفه الهدوء:
— “الجواب ليس عندي يا بني، الجواب خلف هذه العقارب التي سجنتك. والدك قضى سنواته الأخيرة يزرع أشجار الزيتون ويحكي لكل من يقابله عن ابنه الذي يدير أجمل وأطهر مقهى في المدينة. واليوم، حين أتممتَ أنتَ الأربعين، وتساوت سنوات انتظارك مع سنوات غيابه، جاءت ‘دقيقة المطر الأخيرة’ لتعلن اكتمال الدائرة. أدر المفتاح يا يونس، ولكن احذر.. فالحقيقة أحياناً تكون أكثر قسوة من الغموض.”
مدت يدها بالمفتاح نحو يونس، الذي أخذه بيدين ترتجفان وكأنه يمسك بقطعةٍ غالية من روحه. قام يونس نحو الساعة الجدارية الضخمة، وتلمس إطارها الخشبي بقدسية. بحث بلمسات مرتعشة عن ثقبٍ صغير مخفي بدقة خلف زهرة من صدف اللؤلؤ، كان والده قد أشار إليه يوماً في مداعبةٍ قديمة غاب معناها عن ذهنه الطفل آنذاك.
أدخل المفتاح، وبمجرد أن أدار دورةً كاملة، سُمع صوت صريرٍ حاد، ثم صوت تروسٍ معدنية نحاسية تتحرك بشوقٍ وحنين بعد طول صمت. كان صوتاً مهيباً ملأ أركان المقهى، وكأن المكان كله عاد للحياة. انفتح وجه الساعة ليكشف عن درجٍ مبطن بالمخمل الأحمر، وسقطت منه رسالةٌ طويلة مطوية بعناية بخط يد إدريس، وصورةٌ فوتوغرافية قديمة تآكلت أطرافها.
التقط يونس الرسالة وبدأ يقرأ بقلبٍ يخفق بعنف:
“يا بني.. يا من تركتُه خلفي غرسةً في أرضٍ قاحلة. تلك المرأة لم تكن غريبة، بل كانت ‘القدر’ الذي جاء ليسترد دينه من آل إدريس. هذا المقهى ليس مجرد جدران، إنه ‘فجوة زمنية’ حافظتُ عليها لتبقى أنتَ آمناً. لقد قايضتُ وجودي بوجودك؛ خرجتُ معها لكي لا تدخل هي إليك. لقد اخترتُ المنفى في ‘دقيقة متوقفة’ لكي تستمر ثواني حياتك أنت. المفتاح الذي بيدك هو تذكرة العبور.. أدر العقارب الآن، وأطلق سراحنا جميعاً.”
توقف يونس عن التنفس حين التقط الصورة الفوتوغرافية. كانت تجمع والده مع مريم، ويونس الصغير يقف بينهما يضحك بابتهاج.. لكن الصدمة الصاعقة كانت في خلفية الصورة؛ كان هناك رجلٌ يقف بعيداً يراقبهم من خلف زجاج المقهى، رجلٌ يرتدي نفس القميص الذي يرتديه يونس “الآن”، وبذات الملامح والأربعين عاماً التي يسكنها!
أدرك يونس الحقيقة التي تتجاوز العقل: الزمن في هذا المقهى ليس نهراً يجري، بل دائرة مفرغة. تلك المرأة جاءت لتأخذه هو الآن، لكي تستمر الدورة، ليبقى هناك دائماً “يونس” صغير ينتظر، و”إدريس” كبير يرحل.
في تلك اللحظة بالذات، وبقدرةٍ ربانية تزامنت مع انهمار المطر، بدأ الرقاص النحاسي بالتحرك يمنةً ويسرة بانتظام جبار: تيك.. تاك.. تيك.. تاك..
تحركت العقارب لتتجاوز العاشرة وعشر دقائق، معلنةً انكسار قيد الزمن القديم. شعر يونس بجسده يصبح أخف، كأنه يتحول إلى بخار يمتزج برائحة الهيل والورق القديم.
وفجأة، سُمع صوت جرس الباب النحاسي. دخل صبيٌ صغير يرتدي ثياباً مدرسية قديمة مبللة، ملامحه هي ملامح يونس حين كان في العاشرة تماماً. نظر الصبي إلى يونس (الرجل) بذهول وبراءة، وسأله بصوت يرتجف من البرد:
— “عمي.. هل رأيت أبي؟ لقد قال إنه سيعود إلى المقهى قبل أن يدور عقرب الساعة.”
ابتسم يونس بسلامٍ مرير، وهو يرى مريم تهم بالرحيل وتنتظره عند الباب بنظرتها الواثقة. مد يده ومسح على رأس الصبي بحنانٍ أبوي، ثم خلع معطفه الثقيل وألبسه إياه، وقال بصوتٍ هادئ يحمل بحة اليقين:
— “أبوك صار هو المطر يا بني.. وصار هو جدران هذا المكان. انتبه للمقهى جيداً، حافظ على رائحة الهيل، ولا تترك الساعة تتوقف مرة أخرى مهما حدث.”
مشى يونس نحو الباب، وخرج مع مريم إلى العاصفة. لم يشعر ببرد المطر، بل شعر بأن جسده يذوب في القطرات ليكون جزءاً من روح المدينة. وفي المقهى، وقف “يونس الصغير” يراقب الرجل الغريب وهو يختفي في الضباب الكثيف تحت ضوء المصابيح الدافئة.
انغلق الباب. انقلبت لوحة “مغلق” لتصبح “مفتوح”. لقد غادر يونس ليكون هو “إدريس” القادم في حكاية أخرى، وبقي الصغير ليكون “يونس” الذي سيحرس العهد لأربعين عاماً قادمة.
ومع اقتراب الفجر، خف وطء المطر، وبدأت خيوط الضياء الأولى تتسلل من بين السحب، لتعكس نورها على واجهة المقهى التي بدت وكأنها وُلدت من جديد. أدرك المقهى في تلك الليلة أن “دقيقة المطر الأخيرة” لم تكن لحظة نهاية، بل كانت وقفة تأمل ضرورية ليدرك الإنسان أن الغيث لا يأتي إلا بالخير، وأن الحقوق والعهود تُحفظ في القلوب قبل الساعات، تحت حماية زمنٍ لا يرحم، وقلبٍ لا ينسى. المطر لم يغسل الخطايا فحسب، بل غسل الحدود بين الماضي والمستقبل، ليظل مقهى العم إدريس مكاناً خارج الزمان، حيث تولد الحكايات وتُسلم الأمانات من يدٍ إلى يد، تحت ستارة من المطر الأزلي.
تمت بفضل الله
… محمد تمام
![]()