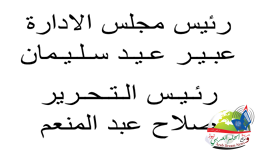تأليف محمد تمام
مع زفراتِ الفجرِ الأولى التي تنفستْ في أزقةِ “الفيوم” العريقة، وبينما كان الصمتُ يغلفُ المدينةَ كدثارٍ صوفيٍّ قديم، استيقظَ “محمد”. لم تكنْ صحوتهُ مجردَ استيقاظٍ روتينيٍّ لجسدٍ أدمنَ البكور، بل كانتْ “وثبةَ روحٍ” تتهيأُ لقطافِ عُمرٍ كامل. توضأَ بماءِ الرضا، وصلى فجرهُ في سكونٍ، ودعواتُه تسبقُ الضياءَ إلى السماء. لم يكنْ “محمد” فلاحاً يحرثُ الطينَ، بل كان “حارثاً للأملِ” في دروبِ الحياةِ المدنيةِ الشاقة؛ رجلٌ عصاميٌّ، نُحتتْ ملامحُه بمساميرِ الصبرِ في مهنتهِ التي استنزفتْ عافيتَه ليصونَ عِرضَ أحلامِ ابنته.
خرجَ من بيتهِ البسيطِ و”شروق” بجانبهِ كأنها نَسَمَةٌ من عبيرِ الصباح. استقلا تلك الحافلةَ المتجهةَ صوبَ “القاهرةِ العامرة”. ومع كلِّ كيلومترٍ تقطعهُ الحافلةُ على طريقِ “مصر – الفيوم”، كان شريطُ الذكرياتِ يمرُّ أمامَ عينيهِ كفيلمٍ سينمائيٍّ طويل؛ رأى تلك الليالي التي عادَ فيها والجهدُ يفتكُ بمفاصلِه، ويداهُ -اللتان لم تلمسا فؤساً بل عركتا مشاقَّ العملِ المدنيِّ المضني- ترسمانِ على جدارِ الحرمانِ طريقاً لابنتهِ نحو النور. لم تكنْ قوانينُ “المرافعاتِ” أو نصوصُ “الجناياتِ” هي لغتهُ، بل كانت لغتهُ الأبلغُ هي “عَرَقُ الكبرياءِ”؛ ذلك الذي بذلهُ ليدفعَ قسطاً جامعياً، أو ليشتريَ مرجعاً قانونياً كان يراهُ لبنةً في صرحِ مجدِ ابنتِه القادم.
حينَ لاحتْ مشارفُ القاهرةِ، وبدأتْ مآذنُها الشامخةُ تطلُّ من خلفِ غبشةِ الضباب، شعرَ بقلبِهِ يخفقُ كطبلِ نصرٍ. وعندما وطأَ رصيفَ العاصمةِ ووقفَ على ضفافِ النيلِ الخالد، بدا “محمد” كأنهُ أثرٌ من آثارِ الأنفةِ؛ رجلٌ سقطَ اسمُه من كتبِ التاريخِ لكنَّ الأرضَ تحفظُ رنةَ خطاهُ جيداً. وجهُه ليس مجردَ ملامحَ، بل هو “خريطةٌ تضاريسيةٌ صادقة” شقّتْ فيها شمسُ الشقاءِ أخاديدَ عميقة؛ تجاعيدُ هي في عُرفِ العابرين كِبرٌ، وفي ميزانِ الحقيقةِ “أوسمةُ شرفٍ” نالها في معاركِ العيشِ الحلال.
في ذلك الصباحِ القاهريِّ المشمس، حيثُ يغزلُ الضياءُ خيوطَهُ فوقَ صفحةِ النهر، وقفَ يتأملُ “شروق”. سكنَ الضجيجُ من حوله، وغابتْ معالمُ المدينةِ المزدحمةِ خلفَ غبشةِ دمعةٍ حبيسة. لم يرَ فيها مجردَ “مستشارةٍ” شابةٍ بزيِّها الأسودِ المهيبِ الذي يلفُّها بوقارِ الفرسان، بل رآها “قربانَ الصبرِ” وسداداً لكلِّ ديونِ التعبِ التي تراكمتْ على كاهلهِ. كانت وقفتُها الشامخةُ هي “الجبرَ الإلهي” لكلِّ انكساراتِ الخاطرِ التي ذاقَها وهو يجمعُ الجنيهَ فوقَ الجنيه، ليضعَها اليومَ فوقَ السحاب.
كانت “شروق” بجانبِهِ كفصيلةِ نخلٍ نبتتْ في أرضِ الإخلاصِ وسقاها أبوها بماءِ الوفاء. عيناها تلتمعانِ بذكاءٍ فطريٍّ لم تمنحهُ إياها الجامعات، بل ورثتْهُ عن “فراسةِ” أبيها. أحكمتْ حجابَها بوقارِ مَن يدركُ ثقلَ الأمانة، وقبضتْ على “كارنيه” النقابةِ بحرصٍ، كأنها تمسكُ بقلبِ أبيها بين كفّيها. هذا الكارنيهُ لم يكنْ لمحمدٍ مجردَ بطاقةٍ، بل كان “شهادةَ ميلادِهِ الحقيقية”؛ الصكَّ الذي يثبتُ للعالمِ أنَّ هذا الرجلَ المدنيَّ البسيطَ قد هزمَ المستحيل.
التفتتْ إليه “شروق”، ولمحتْ في عينيهِ تلك الرعشةَ التي لا تُرى، فأمسكتْ بيدهِ الخشنةِ -تلك اليدِ التي أفنتْ عمرَها لتنعمَ هي بالرفاهِ- وهمستْ بصوتٍ مخنوقٍ باليقين:
”يا أبي.. اليوم تضعُ عن كاهلكَ وقرَ السنين. اليوم، لا أقسمُ بنصوصِ القانونِ فحسب، بل أقسمُ بالعدلِ الذي رأيتُهُ في صمتِكَ، وبالحقِّ الذي تشرّبتُهُ من عَرَقِكَ.”
عبرتْ عتباتِ النقابةِ العتيقةِ، وخلفَها يسيرُ “محمد” بخطواتٍ يمتزجُ فيها وجلُ المحبِّ بفخرِ المنبهر. وفي تلك القاعةِ المهيبة، حيثُ الصمتُ يرتدي وشاحَ الوقار، وقفَ الجميعُ إجلالاً للحظةِ القسم. حانتِ اللحظةُ الفارقة؛ رُفعَ الصوتُ باليمين، فنطقتْ شروقُ بحروفٍ كأنها تنحتُها في الرخام: “أقسمُ باللهِ العظيم.. أن أؤديَ أعمالي بالأمانةِ والشرف..”.
انتهى القسمُ، وفي مشهدٍ سكنتْ له الأنفاسُ، انحنى رأسُ “المستشارة” ليقبلَ تلك اليدَ التي شقّتِ الصخرَ لأجلِها. وتقدمَ محمدٌ، في حركةٍ عفويةٍ هزّتْ أركانَ المكان، وطبعَ قُبلةً غاليةً على جبينِها؛ كانت “ختمَ الجودةِ” على رحلةِ كفاحٍ دامتْ عشرينَ عاماً.
ثم جاءتِ اللحظةُ الألق؛ حينَ دُعيَ هذا الأبُ الوقورُ لمشاركةِ مجلسِ قيادةِ النقابةِ المنصةَ، لتلتقطَ عدساتُ الكاميرا “الصورةَ التذكارية” الكبرى. صورةٌ يظهرُ فيها “محمد” ببدلتِهِ المتواضعةِ ووجهِهِ الذي يفيضُ عزةً، يتوسطُ قاماتِ القانونِ وبجانبهِ ابنتُه. لم تكنْ مجردَ صورة، بل كانت “ملحمةً” تختصرُ حكايةَ وطنٍ يُبنى بإخلاصِ البسطاءِ، وتعلنُ أنَّ الشجرَ الطيبَ في “الفيوم” لا يطرحُ إلا ثماراً مباركةً في “القاهرة”.
لم تكن عقاربُ الساعةِ قد انتصفتْ بعد، لكنَّ الزمنَ في قلبِ “محمد” كان قد توقفَ تماماً عند لحظةِ القَسَم. خرجَ من ردهاتِ النقابةِ العتيقةِ يتهادى في مِشيتِهِ، كأنَّ الأرضَ تحت قدميهِ لم تعدْ أسفلتاً صلداً، بل صارتْ بساطاً أحمرَ فُرِش لملكٍ عادَ لتوِّه من أعظمِ فتوحاتِهِ. بجانبهِ كانت “شروق” تسير، ورداءُ المحاماةِ الأسودُ لا يزالُ يلفُّ كتفيها كوشاحٍ من هيبة، و”الكارنيه” الصغيرُ يلمعُ في يدِها كقطعةٍ من ماسٍ صهرتْها سنواتُ الكدِّ الطويلةِ في دروبِ “الفيوم”.
لفحتْهما شمسُ القاهرةِ الدافئة، فقررَ “محمد” -في لحظةِ كرمٍ أبويةٍ عفويةٍ- أن يتسكعا قليلاً في شوارعِ العاصمةِ العامرةِ قبلَ رحلةِ العودة. سارا نحو “ميدان التحرير”، وهناك، وسطَ زحامِ السياراتِ وضجيجِ المارة، بدتِ القاهرةُ في عينيهِ اليومَ مختلفةً تماماً؛ لم تعدْ تلك المدينةَ الصاخبةَ التي كانت تستنزفُ مدخراتِهِ في أثمانِ الكتبِ وتذاكرِ الحافلات، بل صارت اليومَ “المسرحَ الكبير” الذي ستؤدي فيه ابنتُه دورَ البطولةِ في الدفاعِ عن الحق. توقفَ محمدٌ أمامَ إحدى واجهاتِ المحلاتِ الكبرى، ونظرَ إلى انعكاسِ صورةِ ابنتِه؛ رأى “المستشارةَ” الشابةَ بوقارِها، ورأى خلفَها ذلك الرجلَ الذي أكلتِ الأيامُ من نضارةِ ملامحِهِ ليزهرَ وجهُها هي. التفتتْ إليه شروق، وبصوتٍ يملؤه الحنانُ قالت:
“يا أبي.. أتذكرُ تلك الأيامَ التي كنتَ تعودُ فيها مثقلاً بالتعب، ويدُكَ مرسومٌ عليها شقاءُ يومٍ طويلٍ من العملِ المدنيِّ المضني، فقط لتعدَني بأنكَ ستوصلُني إلى هذه اللحظة؟ ها قد فعلتَها يا حبيبي، وها أنا أقفُ بجانبِكَ والكونُ كلُّه يبتسمُ لنا.”
ابتسمَ محمد، وتنهدَ تنهيدةً أخرجتْ كلَّ أثقالِ السنينِ من صدرِهِ، ثم همسَ: “يا ابنتي.. اليومَ فقط شعرتُ أنَّ غراسي قد أثمر. القاهرةُ التي كنا نهابُ زحامَها، تبدو اليومَ كأنها ترحبُ بكِ كابنةٍ بارة. انظري إلى النيلِ هناك.. إنه يذكرُني بأنَّ الحقَّ كالنهرِ تماماً؛ قد ينحني مسارُه قليلاً، لكنَّ جريانَهُ لا ينقطعُ أبداً.”
دعاها لجلوسٍ قصيرٍ على مقعدٍ خشبيٍّ يطلُّ على النهر، اشترى لها “عقداً من الياسمين” من طفلٍ عابر، ووضعهُ حولَ عنقِها فوقَ رداءِ المحاماةِ في مشهدٍ يجمعُ بين بساطةِ المنشأِ وهيبةِ القضاء. وفي تلك اللحظة، اقتربَ منهما سائحٌ أجنبي، استوقفَهُ شموخُ الأبِ وفخرُ الابنة، فاستأذنَهما في التقاطِ صورةٍ تجمعهما. وقفَ محمدٌ بوقفتِهِ الواثقة، ووضعتْ شروقُ يدَها في يدِهِ الخشنة -تلك اليدِ العصاميةِ التي صمدتْ أمامَ قسوةِ المهنِ لتصنعَ هذا الاستثناءَ- والتقطتِ العدسةُ لحظةً أخرى من لحظاتِ الخلود؛ صورةٌ ستسافرُ خلفَ البحارِ لتقولَ إنَّ العظمةَ الحقيقيةَ تُصنعُ بالحبِّ والشقاءِ الشريف.
ومع اقترابِ موعدِ الرحيل، توجها نحو “محطةِ الجيزة” لركوبِ حافلةِ العودةِ إلى الفيوم. كانت القاهرةُ تودعُهما بأنوارِها التي بدأتْ تتلألأ، ونيلِها الذي يعكسُ ضياءَ الأصيل. في الحافلة، وضعَ محمدٌ رأسَهُ على المقعدِ وأغمضَ عينيه، ليس تعباً، بل ليسترجعَ مشهدَ “الصورةِ التذكارية” التي جمعتْهُ بابنتِهِ مع مجلسِ قيادةِ النقابة؛ تلك اللحظةَ التي جلسَ فيها “المواطنُ الشريف” بجانبِ “سدنةِ القانون”. كان يتذوقُ طعمَ الانتصارِ في صمت، بينما كانت شروقُ تتحسسُ ملمسَ الكارنيه وتنظرُ إلى أبيها، مدركةً أنَّ هذا اليومَ هو “الميثاقُ الغليظ” الذي يربطُ مستقبلَها المهنيَّ بذمةِ هذا الرجلِ وطهارةِ يده.
لم يكن يوماً عادياً في القاهرة، بل كان “يومَ الترسيم”؛ حيثُ انصهرتْ أحلامُ الفيومِ في بوتقةِ العاصمة، لتخرجَ للنورِ محاميةً تحملُ في قلبِها عدلَ السماء، وفي عينيها فخرَ أبٍ لم ينحنِ إلا لخالقِهِ. وعندما غادرتِ الحافلةُ حدودَ العاصمةِ متجهةً نحو الجنوب، كانت الشمسُ تغربُ تاركةً خلفَها وهجاً أحمر، تماماً كوهجِ الأملِ الذي أضاءَ قلبَ “محمد” وهو يعودُ بـ “مستشارتِهِ” إلى أرضِهم الطيبة، ليعلنَ للجميعِ أنَّ “غرسَ الكدِّ” قد حانَ قطافُه، وأنَّ المشوارَ الذي بدأَ بصلاةِ الفجرِ في الفيوم، انتهى بأيقونةِ وفاءٍ ستظلُّ محفورةً في ذاكرةِ الزمان.
غابتْ شمسُ العاصمةِ خلفَ الأفقِ، لكنَّ نُورَها ظلَّ ساطعاً في حدقتيّ “محمد” وهو يرقبُ الطريقَ الصحراويَّ الممتدَّ بين القاهرةِ والفيوم. لم تكنِ الحافلةُ تنقلُ أجساداً، بل كانتْ مِحفةً تَهادى بها حلمٌ صارَ حقيقةً ملموسةً في حقيبةِ “شروق”. سادَ الصمتُ في مقصورتِهِما، وهو صمتٌ لا يشبهُ العدم، بل هو صمتُ “الامتلاءِ”؛ الصمتُ الذي يتلو المعارك الكبرى حينَ تضعُ الحربُ أوزارَها، ويُعلَنُ النصرُ دونَ حاجةٍ لصيحاتٍ أو طبول.
تأمّلتْ “شروق” يدَ أبيها المستريحةَ على ركبتِهِ؛ تلك اليد التي كانتْ طوالَ الرحلةِ بمثابةِ “البوصلة”. نظرتْ إليها ملياً، فرأتْ فيها “صكَّ الغفرانِ” عن كلِّ لحظةِ عوزٍ مرّتْ بها، ورأتْ في مفاصلِها المتعبةِ “فلسفةَ الحقِّ” التي لم تجدْها في مجلداتِ القانونِ الضخمة. أدركتِ الآن، وهي تتحسسُ ملمسَ الكارنيهِ البارد، أنَّ هذا الكيانَ الصغيرَ ليس مجردَ إجازةٍ لمرافعةٍ في المحاكم، بل هو “ميثاقُ غليظٌ” وقّعَهُ أبوها بدمِهِ وعَرَقِهِ وقبلَ ذلك بكرامتِهِ، ليسلّمَها إياهُ أمانةً في محرابِ العدالة.
مالَ رأسُ “محمد” قليلاً نحو النافذة، وبدتْ ظلالُ الأشجارِ العابرةِ على وجهِهِ كأنها تعيدُ رسمَ سنواتِ شقائهِ، لكنها هذه المرةَ كانتْ ظلالاً هادئةً ومستكينة. همستْ شروقُ في سرِّها، وكأنها تُخاطبُ التاريخَ الجالسَ بجوارِها:
“يا مَن علّمتني أنَّ القامةَ لا تنحني إلا لتقبيلِ الأرضِ أو لرفعِ المظلوم.. أقسمُ بظلامِ هذا الليلِ الذي أفنيتَهُ في العملِ لتشرقَ شروقي، أنَّ ميزانِي لن يميلَ، وأنَّ صوتي لن يخفتَ، وأنَّ رداءَك الذي ألبستني إياهُ سيبقى أطهرَ من كلِّ ذمة، وأبقى من كلِّ جاه.”
وحينَ لاحتْ أضواءُ “الفيوم” البعيدة، واقتربتِ الرحلةُ من نهايتِها المكانية، شعرَ “محمد” بلمسةِ ابنتهِ الحانيةِ على كتفهِ، فاستيقظَ من إغفاءةِ الظافرِ بابتسامةٍ لم تعرفْها ثغورُ الملوك. لم يتبادلا كلماتٍ كثيرة؛ ففي ذروةِ النبلِ تصبحُ الأبجديةُ قاصرة. نزلَ الأبُ وابنتُه من الحافلة، فوقفا للحظةٍ أخيرةٍ في سكونِ الليلِ الصافي، حيثُ القمرُ يرقبُهما بإجلال.
نظرَ محمدٌ إلى “شروق” نظرةً أخيرةً قبلَ أن يدلفا إلى بيتِهما، كانت نظرةَ “المؤلفِ” الذي وضعَ النقطةَ الأخيرةَ في أروعِ رواياتِهِ، ونظرةَ “الباني” الذي وضعَ حجرَ الزاويةِ في أعظمِ قِلاعهِ. وضعَ يدَه على كتفِها، وقال بصوتٍ هزَّ وجدانَها:
“يا ابنتي.. اليومَ رددتِ لي عُمري الذي مضى. اليومَ، أستطيعُ أن أنامَ ملءَ جفوني، فالحقُّ الذي حلمتُ بهِ لم يعدْ مجردَ دعاءٍ في صلاتي، بل صارَ حقيقةً تمشي على الأرضِ في ثوبِكِ. كوني مِيزاناً لا يُحابي، وكوني “شروقاً” لا تعرفُ الغروب.”
وهكذا، انقفلتْ دائرةُ الحكاية بسلام. لم تعد القصةُ قصةَ حفلِ يمينٍ أو صورةٍ تذكاريةٍ مع مجلسِ النقابة، بل أصبحتْ “أيقونةً” إنسانيةً تُعلّمُ الأجيالَ أنَّ العظمةَ الحقيقيةَ لا تُبنى بالألقابِ الموروثة، بل تُنتزعُ انتزاعاً من براثنِ الشقاءِ بصبرِ الآباء وعزيمةِ الأبناء. سيبقى ذلك اليومُ محفوراً بمدادٍ من نورٍ في سجلِ الشرفِ لآلِ “تمام”؛ اليومُ الذي التقتْ فيهِ أصالةُ الفيوم بهيبةِ القاهرة، لتُعلنَ أنَّ “ميزانَ الشروق” قد استقامَ كفتُه، وأنَّ النبلَ قد وجدَ أخيراً مستقرَّهُ ومُقامَهُ.
تمت بفضل الله وتوفيقِهِ.
![]()